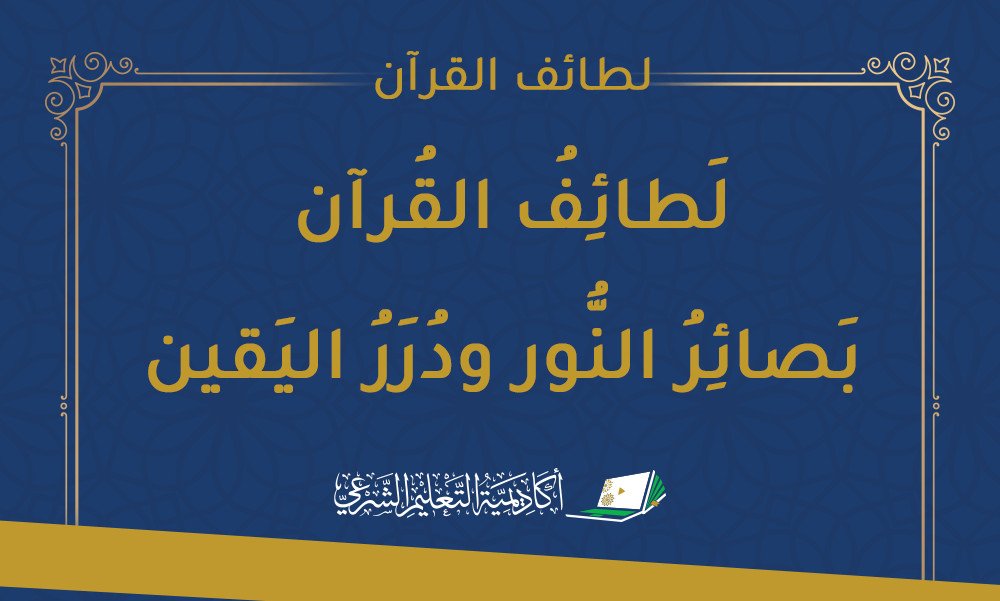بَصائِرُ النُّور ودُرَرُ اليَقين (1) - المفردات القرآنية
د. مصطفى يعقوب
لطائف المفردات القرآنية:
بوابة نحو اليقين من خلال الإعجاز اللفظي
إنّ من أبدع ما يتجلّى به إعجاز القرآن الكريم تلك الدقة المتناهية في اختيار ألفاظه ومفرداته، حيث تأتي كل كلمة في موضعها الأمثل الذي لا يُغني عنها غيرها، ولا يسدّ مسدّها سواها، هذه الدقة تكشف عن عِلم مطلق بأسرار اللغة ودلالاتها وظلالها، وتنأى بالبيان القرآني عن أن يكون من إنتاج عقل بشري محدود.
الدقّة في اختيار اللفظ المناسب للسياق
تأمّل قوله تعالى: ﴿فَٱلۡتَقَمَهُ ٱلۡحُوتُ﴾ [الصّافّات: 142] في وصف ابتلاع الحوت ليونس عليه السلام، فقد اختار الله لفظ "التقم" دون "ابتلع" أو "أكل"، وفي هذا الاختيار لطيفة عميقة؛ إذ الالتقام في اللغة هو الابتلاع دفعة واحدة، مما يُصوّر لنا سرعة الحدث وشدّته وتلقائيته، وكأننا نرى المشهد رأي العين؛ الحوت يفتح فاه ويلتقم يونس عليه السلام التقاماً خاطفاً حاسماً، دون تمهل أو تمضغ، هذا اللفظ بذاته يُغني عن سطور من الوصف، ويختزل مشهداً كاملاً في حرفين وفعل.
وانظر إلى الإيحاء المعنويّ البديع في قوله تعالى: ﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ﴾ [الإسراء: 24]، كم هو مؤثر هذا التعبير! لم يقل "تواضع لهما" أو "كن متواضعاً"، بل شبّه البيان الإلهيّ التواضع للوالدين بخفض الطائر لجناحيه، وهو تصوير بليغ يجمع بين اللين والقوّة، فالطائر يخفض جناحه عن قدرة على الطيران والارتفاع، وهكذا ينبغي أن يكون التواضع للوالدين: ليناً مقتدراً، لا ذلّاً وانكساراً، إنه تواضع المحب القادر الذي يُظهر ذلّه وخضوعه للوالدين من دافع الرحمة، لا من ضعف أو خوف.
التمييز الدقيق بين الألفاظ المتقاربة
من بدائع اللطائف القرآنية ذلك التمييز الدقيق بين الألفاظ المتقاربة في المعنى، مظهراً الفروق الجوهرية بينها، فتأمل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر: 28]، لقد اختار لفظ "الخشية" دون "الخوف"، لأنّ الخشية خوف مقرون بمعرفة وتعظيم، ولذلك خصّها بالعلماء، لأنّهم يخشون الله عن علم وبصيرة، لا عن جهل وتقليد، فكلما ازداد الإنسان علماً بالله وآياته، ازداد خشية له وتعظيماً.
وكذلك نرى الفرق البديع بين "العلم" و"المعرفة" في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآ﴾ [البقرة: 32]، فالعلم أعمّ وأشمل من المعرفة، وهو يتعلّق بالحقائق الكلّيّة، بينما المعرفة تتعلّق بالجزئيّات والتفاصيل، لذا كان استخدام لفظ "العلم" هنا في غاية المناسبة، إذ تحدثت الملائكة عن نفي العلم الشامل عن أنفسها.
التدرج المعجز في ألفاظ الحركة
ومن روائع البيان القرآني ذلك التدرج العجيب في انتقاء ألفاظ الحركة والسعي، الذي يعكس ميزاناً ربانياً دقيقاً لأولويات الحياة وإيقاعات الروح والجسد:
﴿فَامْشُوا﴾ - لطلب الرزق والدنيا: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: 15]، خطوات متزنة دون لهاث، تعكس بدقة ما تستحقه الدنيا من جهدنا - لا إفراط ولا تفريط! فالرزق مكفول، والمشي مطلوب، وليس الركض المحموم.
﴿فَاسْعَوْا﴾ - للعبادة والصلاة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]، حركة أكثر حيوية ونشاطًا، فالعبادة أسمى قيمة من الكسب المادي - تستدعي منا اهتمامًا أعمق وهمة أعلى.
﴿سَارِعُوا﴾ - للخيرات والجنة: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، سرعة تحمل عبق التنافس وروح المبادرة - لأن الجنة أعظم من كل غاية، ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].
﴿فَفِرُّوا﴾ - للجوء إلى الله: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: 50]، ذروة الحركة البشرية وأقصاها، يجمع الفرار بين السرعة القصوى والخشية والشوق الجارف - لأن الله غاية الغايات! هو أعلى مراتب الحركة لأسمى مقصد.
أي إعجاز لفظي ذلك الذي يرسم سلماً متصاعداً في معارج الحركة: مشي ثم سعي ثم مسارعة ثم فرار - كلما علت قيمة المقصد ازدادت درجة الاندفاع نحوه!
لطائف نبوع الماء في القرآن
تأمل كذلك دقة اختيار ألفاظ نبوع الماء في القرآن الكريم، ففي قصة موسى عليه السلام مع قومه يقول تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [البقرة: 60]، بينما في سياق آخر يقول: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [الأعراف: 160].
فالانفجار يختلف عن الانبجاس؛ فالانفجار خروج الماء بقوة وكثرة، والانبجاس خروجه برفق ويُسْر، وقد جاء كل لفظ في سياقه المناسب تماماً، حيث كانت حاجة بني إسرائيل للماء في سياق سورة البقرة أشد وألح، فناسبها لفظ "الانفجار" الدال على الكثرة والقوة، بينما كان السياق في سورة الأعراف أخف، فناسبه لفظ "الانبجاس" الدال على اليسر والرفق.
لطائف "نزّل" و"أنزل" في القرآن
ومن دقائق البيان القرآني اختيار التعبير بـ "نزّل" أو "أنزل" بحسب السياق، تأمّل دقّة البيان في قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النّحل: 89]، لقد استخدم فعل "نزّلنا" بالتشديد الدال على التدريج، لأن القرآن نزل منجّماً مفرّقاً بحسب الوقائع والأحداث، على مدى ثلاثة وعشرين عاماً، بينما في آيات أخرى استخدم لفظ "أنزل" الدال على النزول دفعة واحدة، كما في قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: 185]، وذلك في إشارة إلى نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
التعبير بـ "الفؤاد" و"القلب" في سياقاتها المناسبة
ومن لطائف التمييز بين الألفاظ المتقاربة، استخدام القرآن لكلمة "الفؤاد" تارة و"القلب" تارة أخرى، وفق ما يناسب السياق، فالفؤاد يستخدم غالباً في سياق الإدراك والوعي والتعقل، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36].
أما "القلب" فيستخدم غالباً في سياق العواطف والمشاعر والإيمان، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: 2]، وهذا التمييز الدقيق بين اللفظين المتقاربين يكشف عن عمق بلاغي يتناسب مع التشريح المعنوي للإنسان.
خاتمة: بوابة اليقين
إن لطائف الألفاظ والمفردات في القرآن الكريم تكشف عن دقة بيانية مذهلة، ونظام لغوي معجز، لا يمكن أن يكون من صنع بشر، مهما بلغت فصاحته وبلاغته، وكلما تعمق المتدبر في هذه اللطائف، ازداد يقينه بأن هذا القرآن كلام الله، وأنه حق لا ريب فيه.
هذا الإعجاز اللفظي يفتح لنا بوابة واسعة لليقين، من خلال قاعدة أساسية يمكن تطبيقها على كل آيات القرآن: أن كل لفظة في القرآن جاءت في أدق موضع يليق بها، وأن استبدال أي لفظة بمرادف لها يُخِلّ بالمعنى ويُفقِد النص تماسكه وقوته وإعجازه.
فلنحرص على تدبر ألفاظ القرآن الكريم، ولنغص في بحار معانيها، لنستخرج درر لطائفها، فكل لفظة فيه عالمٌ من الإعجاز، وبابٌ من أبواب اليقين.